القصيدة بين التشكّل والتفكك المستمر قراءة في نص محمد الماجد "ألم تقل إنها قصيدة؟"
عبدالغفور الدهان
من قلب الوطن، المملكة العربية السعودية، تطلق وزارة الثقافة الموسم الثاني للمسابقة الشعرية السنوية (المعلقة)، حيث تجمع نخبة من الشعراء العرب في منافسة إبداعية تمتد لأكثر من شهر. سيتم تكريم القصائد الفائزة بتعليقها في موقع مميز بالرياض، ضمن مراسم احتفالية تليق بمكانة الوطن، تتميز مسابقة (المعلقة) بأسلوب تحكيم مبتكر يسهم في دعم الشعراء وتطوير مسيرتهم الإبداعية، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الشعرية بالقصائد النوعية. كما تهدف إلى اكتشاف المواهب الشعرية الشابة وتمكينها، بما يسهم في بناء جيل جديد من الشعراء المتميزين، وقد أتاحت المسابقة المجال لأكثر من نوع شعري، حيث شملت الشعر الفصيح،و النبطي، والحر. وفي هذا السياق، ستكون قراءتنا لقصيدة الشاعر محمد الماجد، المصنفة ضمن الشعر الحر، وفق التصنيف الذي اعتمده المنظمون.
تتأرجح القصيدة بين التشكّل (الكتابة) والتفكّك (إعادة القراءة والتأويل)، مما يجعلها كيانًا متحرّكًا لا يستقر عند شكل أو موقع ثابت. هذا التبدّل أشار إليه الشاعر محمد الماجد في مطلع قصيدته، عندما وصف نفسه بأنه “حرف روي مجروش”، مقترحًا في الوقت ذاته رفع القصيدة إلى بحور الشعر، لـ “الكامل” وأخيه “الطويل”، رغم أن النص يصنَّف شكليًا ضمن الشعر الحر وفق رؤية المنظمين، فإن هذا الحراك الإبداعي الدائم، سواء في أثناء الكتابة أو خلال القراءة والتأويل، يمنح القصيدة طبيعة مراوغة تجعلها نصًا مفتوحًا لا يخضع لقوالب محددة ، تستدعي هذه المراوغة حالة الصعاليك، الذين ظلوا شخصيات غامضة، متأرجحة بين الحقيقة والأسطورة، تمامًا كما ظلت القصيدة محطّ اختلاف بين النقاد والتيارات الأدبية في تعريفها وتحديد هويتها.
وهذا ما عبّر عنه الماجد في نصّه، حين قدّم القصيدة ككائن ملتبس، يتنقل بين العوالم، يدخل في الإنس ويخرج من الجن، ثم يتمدّد على ماء الحرير في تماهٍ فاتن مع الملائكة. إنه توصيف يعكس المخاض الذي مرت به القصيدة ذاتها عبر التاريخ، من تأويلات وتعريفات متعدّدة، جعلتها كيانًا متجدّدًا لا يستقر عند شكل واحد، بل يظل دائم التشكّل والانفتاح على قراءات جديدة.
في كتابه “الكتابة والتناسخ”، يقدم الأديب الكبير عبد الفتاح كيليطو مفهومًا محوريًا في تحليل النصوص الأدبية، حيث يرى أن كل كتابة هي في جوهرها كتابة فوق نصوص سابقة. وهذه العملية، كما يوضح، لا تعد تكرارًا بل هي إعادة تشكّل للتجارب الأدبية بما يتناسب مع اللحظة الإبداعية الجديدة. في نص “ألم تقل إنها قصيدة؟” يظهر التفاعل العميق بين النص والمرجعيات التراثية بوضوح، حيث يقف الشاعر ليُقْسِمَ أمام جمهور المعلقة و المتلقي بـ”كلّ سُلَكَةٍ” و بـ”كلّ لاميةٍ”، هذان قسمان يحملان قيمة رمزية وثقلاً دلالياً يعيد القارئ إلى صميم التاريخ الأدبي والشعري. بهذين القسمين، يبرز الشاعر فكرة أن النص ليس مجرد تفاعل مع التراث، بل امتداد حي له، وكأنما يريد القول أن ذاته تنبع من أعماق بئر التراث، مُرسخًا انتماءه لهذا الإرث الإبداعي الذي لا ينفصل عنه.
” أَقسمُ عليكم بكلّ سُلَكَةٍ نذَرَتْ ما في بطنها للنهب والغارة،
وبكلّ لاميّةٍ أوقفت أطفالَ البلاغة دون شفقةٍ على أطراف أصابعهم،”
يبدأ القسم الأول من النص بـ “كلّ سُلَكَةٍ نذَرَتْ ما في بطنها”، في إشارة ضمنية إلى السُّليك بن السُّلَكة التميمي والذي يعد من أغربة العرب كما يشير شوقي ضيف في كتابه تاريخ الأدب العربي أثناء تصنيفه الصعاليك إلى ثلاث مجموعات إذ يقول “ومجموعة من أبناء الحبشيات السود، ممن نبذهم آباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم مثل السّليك بن السّلكة وتأبّط شرّا والشّنفرى، وكانوا يشركون أمهاتهم فى سوادهم فسموهم وأضرابهم باسم أغربة العرب”، إذن، السُّليك هو الشاعر الصعلوك الذي تمرّد على قبيلته ورفض قيودها بعدما حرمته من المكانة التي يستحقها كسائر أبناء القبيلة، مجسّدًا في شخصيته جوهر التمرد والحرية المطلقة. كان السُّليك نموذجًا للصعلوك الخارج عن الأعراف والمألوف، الذي جعل من النهب و الغارة أسلوب حياة، متجردًا من كل انتماء إلا لانحيازه للحرية. أما القسم الثاني، فكان بـ “كلّ لاميةٍ”، و هو ما يحيل بوضوح إلى القصيدة الشهيرة المنسوبة للشنفرى “لامية العرب”، تلك التحفة الأدبية التي نقلت حياة الصعاليك بكل تفاصيلها القاسية، وجسّدت صراعهم المستمر من أجل البقاء. في هذه القصيدة، رسم الشنفرى مشهدًا حيًا لحياة الصعلكة، حيث الجوع، التيه، والقتال ضد الطبيعة والقبيلة على حد سواء. تلك اللامية كانت بمثابة يافطة احتجاج وتمرد ورفض للنظام القبلي، منذ أن أعلن الشنفرى قطيعته مع قومه وقبيلته بكل تحدٍ وجرأة حيث يقول:
أَقِيمُوا بَنِـي أُمّـِي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ فَإنِّي إلى قَوْمٍ سِوَاكُمْ لَأَمْيَلُ
فَقَدْ حُمَّتِ الحَاجَاتُ وَاللَّيْلُ مُقْمِرٌ وَشُدَّتْ لِطِيّاتٍ مَطَايَا وَأرْحُلُ
من الواضح أن الماجد يستدعي الصعاليك كأداة استقواء في مواجهة من يختلف معهم، أولئك الذين يرفضون الاعتراف بقصيدة النثر أو بأسلوب الكتابة الحداثية، ينبذونها ويحيطونها بالعار، تمامًا كما فعل آباء الصعاليك بأبنائهم حينما أنكروهم ونسبوهم إلى أمهاتهم السود، يتحدى الماجد هذا النسق الأدبي، ويواجه الذائقة الرافضة لنوعية الكتابة الحداثية من خلال إيقاظ شعور العجز في نفوس من يختلف معهم و في الآن نفسه يستدرج جمهور المعلقة ليساهم معه بالتعرف على القصيدة هذا الكائن الملتبس بطلب الإستشارة منهم ، فيقول:
“وبكل شنفرى خر عليهم من السقف
وسد الأبواب،
إلا ما أشرتم علي
فأنا مُقْمِرٌ والليل طويل”
في هذا المقطع تتجلى مفارقة الصعلكة الشعرية التي يوظّفها الماجد بذكاء، حيث يتعامل مع خصومه من جهة وجمهور المعلقة و المتلقي من جهة أخرى بأسلوبين متباينين. فهو مع خصومه يضرب بقوة، كأنما يهدم سقف يقينهم فوق رؤوسهم، مفاجئًا إياهم بانهيار ما كانوا يعدّونه ثابتًا، وكأنهم محاصرون داخل نصه، فلا مجال للهرب أو الإنكار حين “يخر عليهم من السقف”، ثم يسد الأبواب ليقطع عليهم أي فرصة للهرب من المواجهة، لكنه في ذات اللحظة، يترك الباب مواربا حين يقول: “إلا ما أشرتم عليّ”، وهنا يكمن الاستدراج الذكي لجمهور المعلقة والمتلقي فهو لا يصادر رأيهم، بل يعرض عليهم فرصة للمشاركة، يضعهم في موضع الشاهد على التجربة الشعرية، وكأنه يستشيرهم، لكنه في الحقيقة يختبر استعدادهم للانخراط في النص. أما العبارة “فأنا مُقْمِرُ والليل طويل”، فهي أيضا تعبير صعلوكي بامتياز ، إنه إعلان مناظرة مفتوحة، فهو لا يغلق الباب تمامًا، بل يتركه مفتوحًا على احتمالات متعددة، كأنما يقول: “الليل طويل… فهل ستبقون معي حتى النهاية؟”.
إذن اللغة عند الصعاليك لم تكن مجرد أداة تعبير لواقعهم، بل كانت سلاحهم الأكثر فتًكا في معاركهم مع المجتمع ، يرسمون بها تفاصيل واقعهم، ويفضحون ظلم أولي القربى، ويجسدون ملامحهم من أخمص أقدامهم إلى قمة رؤوسهم، وكأن لغتهم امتداد لظلالهم القلقة والمتمردة. أما الماجد، فقصته تختلف لحد ما؛ لم يكن صعلوكًا، لكنه ارتدى عباءتهم بإرادته، مستلهمًا روحهم الثائرة لا لينتمي إليهم عضويا، بل ليعيد إحياء تمردهم لا على القبيلة بل على النسق الأدبي المنغلق على تراثه، حيث يقف في مواجهة من أراد للقصيدة أن تتحنط وأن تصبح مجرد صدى لتراث يُعاد اجتراره دون أن تُنفخ فيه روح جديدة أو يُسكب فيه إبداع خلاق.
يبدأ النص بسؤال استنكاري يحمل في طياته دلالة تشكيكية حول ماهية القصيدة في قوله: “ألم تقل إنها قصيدة؟”، و يبدو أن غاية الشاعر لا تكمن في تقديم إجابة واضحة، بل في استدعاء أسئلة أعمق تنبع من حواره مع التراث ذاته. فالقصيدة، في هذا الإطار، تتجاوز حدود التعبير عن الجمال لتتحول إلى مشروع فكري يعيد النظر في مفهوم الشعر ويعيد تفكيك بنيته لإعادة تشكيلها برؤية مبتكرة. وعلى الرغم من أن هذا الطرح والجدل ليس جديدًا، إلا أن اهتمام الماجد بهذا الموضوع يشير ضمنيًا إلى عنايته بالكتابة الإبداعية والنقدية على حدٍ سواء وإن صرّح بأنه لا يكترث كثيرًا بآراء النقاد أو النقد، إن موضوع السؤال عن النص نفسه أو القصيدة ذاتها بوصفه سؤالًا عن الماهية، يدخل في إطار الأسئلة الميتاشعرية التي تثير تساؤلات حول طبيعة الشعر، ماهيته، وظيفته، وكيفية تلقيه. لذلك أختار الشاعر أن يكتب نصًا يجمع بين البعد النقدي الضمني من جهة، والبعد الأدبي الجمالي من جهة أخرى، مما جعل “القصيدة تغنّي، ولكنها تفكّر أيضاً”، كما يشير إلى ذلك فوزي كريم في كتابه “القلب المفكر“.
إذن، نحن أمام نص لا يكتفي بأن يكون (موضوعًا) للتقييم، بل يسعى أيضًا لأن يكون (محمولاً ) للتعبير عن رؤيته تجاه النصوص الأخرى وكل ما يُكتب. وهذا يستدعي إعادة النظر في طريقة قراءته، فهو لا يطرح نفسه كمجرد موضوع للنقد، بل يعبر عن رؤية مستقلة بذاتها. وهنا تكمن المفارقة والتحدي في التعامل مع نصوص كهذه، حيث يصبح تقييمها امتدادًا للحوار الذي تفتحه مع القارئ.





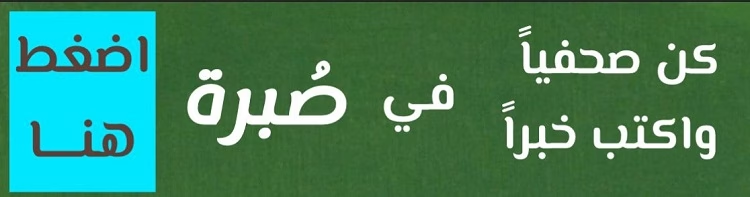

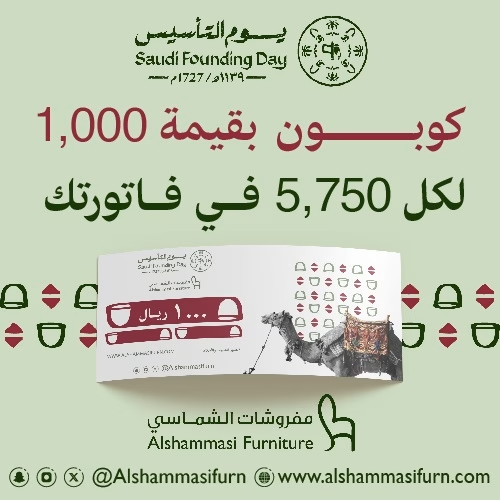

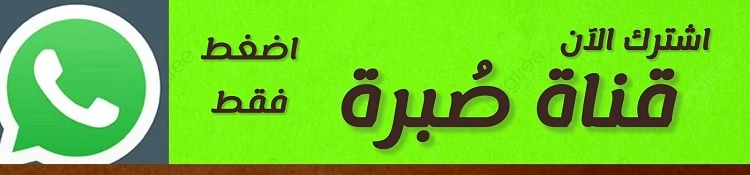






قراءة مستفيضة وفاتنة لنص الشاعر محمد الماجد بالإضافة إلى إضاءتها لمناطق ربما فاتت على القاريء العابر، قصيدة النثر تحتاج لهذا التأمل والقراءة المستديرة، حيث كلما تقدمت، تعود للخلف مرات عدة لاستنطاقها.